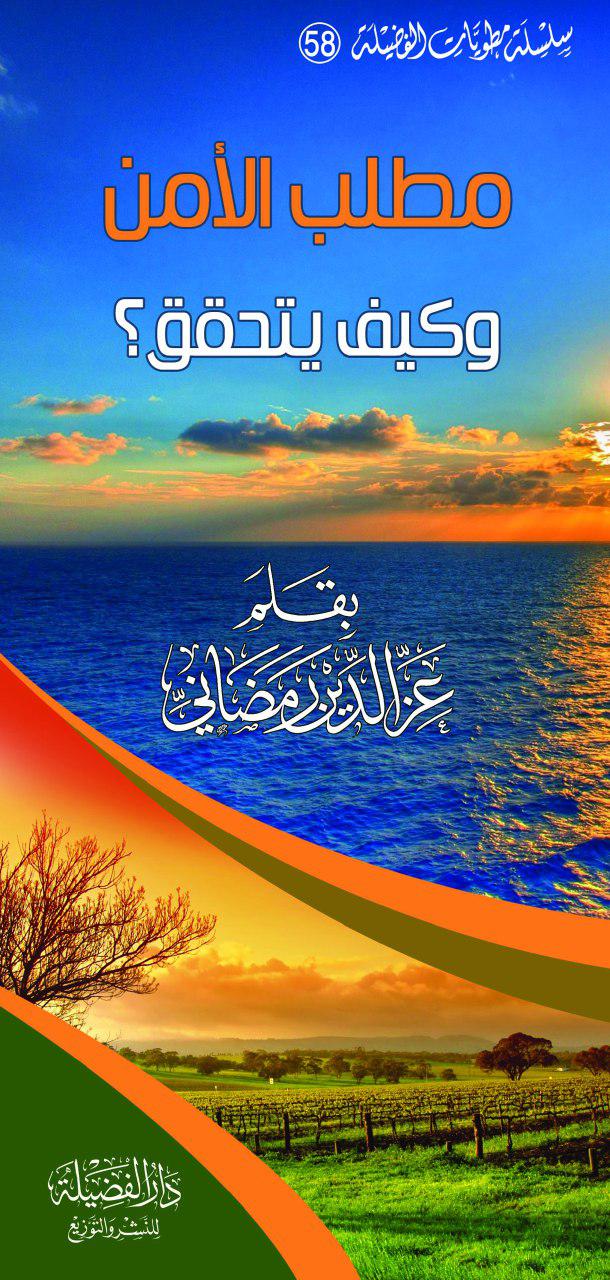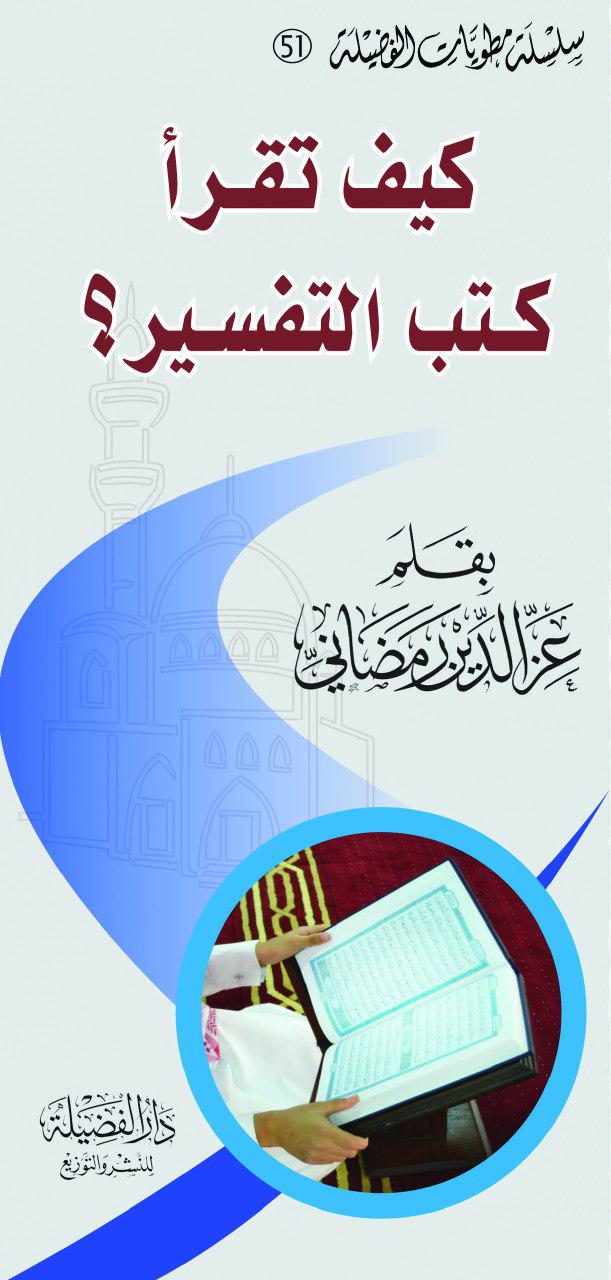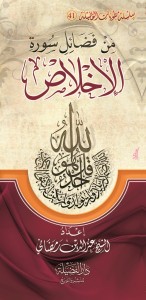- الرّئيسية
- فقه وأُصول
- فقه النَّصيحة عند الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم
فقه النَّصيحة عند الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم
إنَّ مِنَ الحقوق العظيمة والواجبات الثَّقيلة الَّتي لا يقوى عليها إلَّا من صفا قلبُه من الدَّغَل، وسَلِمَ لسانُه من الدَّجل، وتهيَّأ لأمانةٍ عظمى، ووهب نفسَه لخدمة أسمى، الحفاظ على سلامة الأديان والأعراض والأنفس والأموال، ولا يكون ذلك إلَّا بإسداء النَّصيحة وتقبُّلها على الوجه الأكمل والمرضيِّ، فهي نور سارٍ بين الأمَّة تشتدُّ بها صِلاتها وتتوثَّق من خلالها روابطها، إذ أنَّها تمثِّل في حقيقتها إرادة الخير للمنصوح له، وقد عرَّفها ابن الصَّلاح بقوله: «النَّصيحة كلمة جامعة تتضمَّن قيام النَّاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلًا»([2]).
وحسبنا بفضيلة النَّصيحة علوًّا وشرفًا أنَّها من الصِّفات الَّتي تحلَّى بها الأنبياء وسما بها الأتقياء الَّذين قام تبليغهم للرِّسالات السَّماويَّة على القول الصَّادق والبلاغ المبين والنُّصح الأمين، كما قال أوَّل الرُّسل نوح عليه السلام: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62) ﴾ [الأعراف]، وكما قال هود عليه السلام: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) ﴾ [الأعراف]، وكما قال صالح عليه السلام: ﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) ﴾ [الأعراف]، وكما قال شعيب عليه السلام: ﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) ﴾ [الأعراف].
وقد جاء في شرعنا المطهَّر الأمر بها، أداءً وطلبًا، فكان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَة» وكرَّرها مرارًا إشارة منه إلى أهميَّتها ودورها في حياة المسلمين، وأنَّ الدِّين كلَّه ظاهره وباطنه منحصرٌ في النَّصيحة حتَّى قال أبو داود: «الفقه يدور على خمسة أحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم: «الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، وكان الحافظ أبو نعيم يقول في هذه العبارة: هذا حديثٌ له شأنٌ، وذكر محمَّد بن أسلم الطُّوسي أنَّه أحد أرباع الدِّين، وقال النَّووي: «بل هو وحده محصِّل لغرض الدِّين كلِّه»([3])، وتفسير ذلك أنَّ النَّصيحة جمعت كلَّ خير يبتغى ويؤمر به، وكلّ شيء يتَّقى وينهى عنه.
وممَّا يبيِّن أنَّ النَّصيحة من مهمَّات الأمور وسوابق الفروض، أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم عقدوا البيعة لأجلها، وتعهَّدوا أمام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على بذلها مقرونة مع أعظم شعائر الدِّين وخصال الإسلام وهما إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة، ففي «الصَّحيحين» عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهم قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة، والنُّصح لكلِّ مسلم»([4]).
وفي بعض روايات الحديث: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشَرط عليَّ: والنُّصح لكلِّ مسلم»([5]).
وهذا يدلُّ على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمَّته حيث لم يستثن أحدًا ولو كان فاسقًا، ولنا أن ننظر إلى سَمْتِ هذا الصَّحابي الجليل، كيف تشبَّث بهذا العهد إلى أمد طويل، فإنَّه من حين أخذه البيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذل النُّصح لكلِّ مسلم، لم يَدَعْ وقتًا يمرُّ عليه، أو فرصةً سانحةً تساق إليه إلَّا وبذل لهم نصحَه، وأسبل عليهم عطفَه، إمَّا فعلًا هاديًا، وإمَّا قولًا مواتيًا، أمَّا الفعل فقد روى ابن حبَّان (4616) بإسناد صحيح أنَّ جريرًا رضي الله عنه«كان إذا اشترى شيئًا أو باعه يقول لصاحبه: اعلم أنَّ ما أخذنا منك أحبُّ إلينا ممَّا أعطيناكه؛ فاختر».
وروى الطَّبراني في «الكبير» (2/235) في ترجمته أنَّ غلامه اشترى له فرسًا بثلاثمائة درهم، فلمَّا رآه جاء إلى صاحبه فقال: إنَّ فرسك خير من ثلاثمائة، فلم يزل يزيده حتَّى أعطاه سبعمائة درهم أو ثمانمائة».
فهذا هو النُّصح المنافي للغبن، والصِّدق المنافي للغشِّ، فأين هذا من غدر بعض الباعة بزبائنهم، يكتمون عنهم عيوب السِّلع ثمَّ يتحدَّثون بعد ذلك فخرًا وسخريَّة أنَّهم استغفلوهم وغرَّرُوا بهم.
وأمَّا القول؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» من كتاب الإيمان (58) أنَّه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ـ وكان واليًا على الكوفة في خلافة معاوية رضي الله عنه ـ قام جرير بن عبد الله رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: «عليكم باتِّقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسَّكينة، حتَّى يأتيكم أمير، فإنَّما يأتيكم الآن.
ثمَّ قال: استعفوا لأميركم، فإنَّه كان يحبُّ العفو، ثمَّ قال: أمَّا بعد: فإنِّي أتيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام فشرط عليّ: والنُّصح لكلِّ مسلم، فبايعته على هذا، وربِّ هذا المسجد إنِّي لناصح لكم، ثمَّ استغفر ونزل».
وفي هذه الخطبة وقفة سنيَّة، تحمل فقهًا وعلمًا، وتملي سياسة شرعيَّة، وترسم منهجًا أصيلًا وتكشف قناعًا مضلَّلا.
فهذا الصَّحابي لما مات أمير البلاد قام في النَّاس خطيبًا على وجه بذل النَّصيحة للخلق، وليس له في الأمر مطمع، ولم يقم فيهم مهَيِّجًا للضَّغائن مثيرًا للعواطف، ومن فطنته رضي الله عنه أنَّه انتهز الوقت المناسب للتَّذكير، وفي ظرف غاب فيه التَّدبير والتَّأمير، فقطع السَّبيل على السُّفهاء والجهلاء، وتكلَّم بلسان العقلاء والعلماء، فكان أوَّل ما أمرهم به هو تقوى الله تعالى، رأس الحكمة ومفتاح الحلّ، إذ هي العاصم من كلِّ هول، والمنجية من كلِّ فتنة مدلهمَّة، وإنَّما قدَّم التَّقوى؛ لأنَّ الغالب أنَّ وفاة الأمراء تؤدِّي إلى الاضطراب والفتنة ولاسيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور.
ثمَّ حثَّهم على التزام الوقار وهو الرَّزانة والحكمة والتَّعقُّل، وأردفه بالسَّكينة وهي السُّكون والهدوء، وترك الغوغاء وإثارة الفوضى والشَّغب، فجمع لهم بين رَجَاحة العقل وسلامة التَّصرُّف والعمل، وهما أمران ما اجتمعا عند شخص أو قوم إلَّا كان حظُّهم النَّجاة والسَّلامة، ومن فقدهما لم يحصد إلَّا الخزي والنَّدامة.
ولنا أن نتأمَّل في الحكمة الَّتي أوتيها هذا الصَّحابي وفي نظره البعيد وتقديره للعواقب لَمَّا قال لهم: حتَّى يأتيكم أمير، لما يعلم أنَّ النُّفوس ميَّالة إلى الطِّيش مهيَّأة للانتقام عند غياب الرَّادع والمؤدِّب، لذلك أمرهم بكبح جماح النُّفوس بوازع التَّقوى وارتداء لباس الوقار والسَّكينة إلى حين استخلاف الأمير الجديد.
ولم يقيِّد رضي الله عنه الأمير المستخلف بوصف الصَّلاح، بل قال أمير.
وهذا فيه من الفقه أنَّ الأمير حتَّى لو كان فاسقًا وعنده جور وظلم فوجوده خير من عدمه، وفي ولايته جلب للمصلحة ودرء للمفسدة؛ لأنَّ الله يزع بالسُّلطان ما لا يزع بالقرآن.
ثمَّ إنَّه عاجلهم البشرى، ولم يتركهم للحيرة، بل قال لهم: «إنَّما يأتيكم الآن»: وقد حمله على هذا القول حسن ظنِّه بالخليفة وإن لم يُعْلِمْهُ بإرسال الأمير، وقَرَّب لهم المدَّة تسهيلًا عليهم لا تيئيسًا لهم من الانتظار، وقد كان الأمر كذلك، فهو رضي الله عنه لما كان صادقًا في نصحه للأمَّة بعث معاوية إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرًا عليها.
ثمَّ قال: «استعفوا لأميركم» أي اطلبوا له العفو من الله، والمقصود الأمير المتوفَّى، وهذا من الإحسان للموتى بدل الخوض في مثالبهم، والتَّشهِّي بذكر معايبهم، اعترافًا بالفضل وامتنانًا بما قدَّمه للأمَّة من رعاية مصالحها والقيام بشؤونها.
وقد علَّل طلبه للعفو بما كان عليه الأمير المتوفَّى من خلقٍ قويم وأدب سليم، حيث كان يحبُّ العفو إشارة منه إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل.
وختم رضي الله عنه خطبته هذه ببيان الدَّافع الَّذي اضطرَّه إلى تقديم هذه النَّصيحة الغالية وهو وفاءه بالشَّرط الَّذي قطعه مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ببذل النُّصح لكلِّ مسلم، وقد وفَّى به قبل أن يدركه الموت، وأكَّده بالقسم، وبيَّن أنَّ كلامه خالص عن الغرض والطَّمع.
وهكذا؛ فليكن النُّصحاء أو لا يكونوا، ثمَّ انظر هل يستوي هذا العاقل النَّاصح رضي الله عنه مع ذلك المهيِّج الثَّوري وما أكثرهم في زماننا الَّذين يستغلُّون فقدان وعي الجماهير، ويتاجرون بلحظات هوسهم وجنونهم ويدفعون بهم إلى الشُّرور والمهالك، وقانا الله شرَّ الضَّلال والرَّدى وجمع كلمتنا على الحقِّ والهدى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه ومن اتَّبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.
* * *
([1]) نشر في مجلة «الإصلاح»: العدد (14)/جمادى الأولى 1430هـ.
([2]) «صيانة صحيح مسلم» (ص221).
([3]) انظر: «فتح الباري» (1/138).
([4]) البخاري (57)، ومسلم (97).
([5]) البخاري (58).
(عدد المشاهدات6859 )

يُبث في الإذاعة
جديد الموقع
تابعنا على الفايس بوك
موعظة الأسبوع
قالَ الإمامُ ابنُ حزمٍ -رحمه الله- : «إذا حضرت مجْلِس علمٍ فَلا يكن حضورك إِلاّ حُضُور مستزيدٍ علمًا وَأَجرًا، لا حُضُور مستغنٍ بِمَا عنْدك طَالبًا عَثْرَة تشيعها أَو غَرِيبَةً تشنِّعها، فَهَذِهِ أَفعَال الأرذال الَّذين لا يفلحون فِي الْعلم أبد
اقرأ المزيدالأكثر مشاهدة
زوّار الموقع
- موقع راية الإصلاح
- موقع الشيخ فركوس
- موقع الشيخ عبد الغني عوسات
مواقع مفيدة :